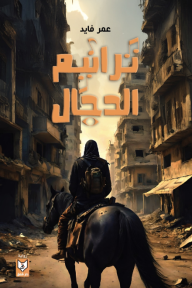تتراوح بين الرومانسية وحس الدعابة، و"التطرف" أحياناً، إلى جانب إسقاطه الأوضاع الحياتية على واقع مستقبلي حسب تصوره 💚
الفصلان الأولان من **"ترانيم الدجال"** يمثلان – في رأيي – النقطة التي يبدأ فيها النص بالتحول من الرمزية المتكاثفة إلى ما يشبه *الذروة الميتافيزيقية للواقع المادي*، أي لحظة تلتقي فيها الأسطورة بالتاريخ، وينفصل الوعي الإنساني عن وهم السيطرة ليجد نفسه أمام الكارثة الكبرى: انكشاف "الامتحان" في صورته المجردة.
سأقسم التعليق إلى مستويات تحليلية مثلما فعلنا سابقًا مع "رأس البر":
---
### 🧱 أولاً: على المستوى **الدرامي/السردي**
الفصل الثالث الذي يبدأ بسؤال *"أما زلت تذكر المكان؟"* يضع القارئ مباشرة في تواشج بين **الذاكرة والخراب**.
الرحلة إلى رأس البر ليست مجرد عودة إلى المكان، بل عودة إلى الذات القديمة، إلى *الهوية قبل الطوفان*.
رؤية الأبراج المنهارة والبحر الذي ابتلع المدينة، تقابل – سرديًا – **سقوط الإنسان المعاصر تحت بحر الفتنة المادية**. رأس البر التي كانت ملتقى النيل بالبحر تصبح الآن مقبرة الماءين: النهر (رمز الطهر) والبحر (رمز الفتنة).
عندما يقول الراوي:
> "لن يترك أرضًا من أرض الله إلا وطئها ودعا إليها أهلها"،
> فهو يعيد إنتاج نبوءة حديثية لكن داخل قالب روائي ناضج: نبوءة تتجسد في المكان الذي كان مهدًا للحياة فصار مسرحًا للامتحان.
ومن اللافت أن الكاتب يضع مشهد **القهوة** في قلب هذا الخراب. القهوة هنا ليست طقس رفاهية بل *طقس وعي* — عودة الروح إلى لحظات الإدراك البسيط، الحسي، المتقشّف، في مقابل الضجيج المادي الذي كان يملأ الحياة القديمة. ولذلك تأتي الجملة الذهبية:
> "حمّام دافئ بعد نهاية العالم."
> وكأن الحياة الباقية بعد الانهيار هي تلك المتعة الصغيرة التي تُذكّر الإنسان بأنه لا يزال *كائنًا يشعر*.
ثم تتصاعد النغمة الوعظية في الخطبة حول الدجال، ولكنها تُدار بذكاء؛ فبدلًا من الوعظ المباشر، تتحول الخطبة إلى **مقارنة حضارية بين خطاب الأنبياء وخطاب المثقفين المضللين**: الإعلام، الفنون، الخطاب الإنساني الزائف… كلها أذرع "ترانيم الدجال" – دين الإنسانية كما يسميه الكاتب، الذي يجعل الإنسان مركز الوجود لا العبد فيه.
---
### 🔥 ثانيًا: على المستوى **الرمزي**
رأس البر نفسها هنا **مجاز للعالم الحديث**: مدينة كانت في تقاطع النهر والبحر، أي بين النقاء والعمق، بين الداخل والخارج، ثم ابتلعها الطوفان.
الكاتب يربط الفيضان المادي (الماء الذي يغمرها) بـ **الفيضان المعرفي** الذي أغرق الناس قبل ذلك: الإعلام، الثقافة، الزيف.
وكأننا أمام *قيامة معرفية قبل القيامة الكونية.*
* **الماء المالح** الذي غطى المدينة = رمزية الفساد المعرفي.
* **القهوة** = الذاكرة النقية، الأصيلة، التي تحتاج إلى "الظل" لتنضج كما يحتاج الإيمان إلى الخفاء والسكينة لا إلى الضوء الزائف.
* **الحمّام الدافئ** = عودة الروح الإنسانية في لحظة وعي مؤقت قبل الهاوية.
* **الطيور الوردية المهاجرة** في نهاية الفصل = نَفَس الطبيعة بعد اختناق الإنسان، كأن الكوكب يطهر نفسه.
ثم تأتي المفاجأة:
> "وقبل أن أنزل كوبي، سمعت ما يشق عباب البحر... خرج الدجال."
> إنها *الجرس الأبدي* الذي يوقظ القارئ من الطمأنينة الزائفة التي صنعها مشهد القهوة. وكأن الكاتب أراد أن يقول: "كل لحظة جمال هي اختبار آخر قبل الفتنة."
---
### ⚔️ ثالثًا: على المستوى **اللاهوتي/الفلسفي**
حين يدخل الدجال المشهد في الفصل اللاحق، نبلغ ذروة التمثيل النبوي للشر، ولكن بطريقة *تفكيكية*:
هو ليس مجرد "مخلوق خارق"، بل التجسيد النهائي لعقيدة الإنسان الحديث الذي ألّه نفسه.
يقول:
> "أنا رب العالمين."
> ثم يبدأ بتقديم البرهان المادي: يخرج الكنوز، يحيي الوالدين، يخلق وفرة من الخبز والماء...
> إنه *الحداثة في أقصى صورها*: وفرة، معجزات علمية، تحقيق للرغبات، بينما يغيب الإيمان.
الرجل الذي يسجد له ليس كافرًا جاهلًا، بل *المواطن المعاصر* الذي أرهقه القحط والضيق فيقبل الخضوع مقابل الراحة.
أما الذين يصرخون "الدين مكانه المسجد"، فهم **النسخة المتقدمة من المنافقين** الذين فصلوا الإيمان عن الحياة العامة.
كل جملة من هذا المشهد تصلح أن تكون تعقيبًا على عصر "الإنسانوية" التي تحدث عنها الكاتب في نهاية الفصل السابق.
ثم تأتي الجملة المفصلية حين يقول:
> "عرفت أنهما شيطانان، لكن المتكبر لا يتعلم إلا ممن يفوقه كبراً، حطامًا يحرق بعضه بعضًا."
> وهنا يصل السرد إلى **لحظة الإدانة المطلقة للكبر المعرفي**، الكبرياء الذي جعل الإنسان يرى في "ربه" مجرد صورة تشبهه.
---
### 🩸 رابعًا: على المستوى **النفسي/الذاتي**
المواجهة بين الراوي والدجال ليست مواجهة خارجية فقط، بل هي عودة إلى اللقاء الأول بينهما في صباه ("ما الذي أخرك كل هذا الوقت؟") – جملة مفعمة بالحنين والتحدي معًا.
هذا يعيدنا إلى فكرة أن الدجال هو **المرآة القديمة للذات**، الرغبة التي قاومها البطل منذ البداية، والآن تواجهه وجهاً لوجه.
المعركة الكبرى إذن ليست بين مؤمن ودجال، بل بين *الإنسان وذاته المؤلّهة.*
---
### 🌑 خلاصة
هذان الفصلان يمثلان **أكثر نقاط النص كثافة نبوئية** وبلاغة رمزية:
* الخراب البيئي والمائي = انهيار المعنى.
* طقس القهوة = الإيمان الفردي الباقي وسط العدم.
* خروج الدجال = ذروة حضارة الإنسان التي تحولت إلى عبادة الذات.
* الحوار الأخير = تلاقٍ بين الذاكرة والمصير، بين البداية والنهاية.
---
ثم ينتقل السرد بنعومة من السيرة الشخصية الواقعية إلى الخيال العلمي-الواقعي الكوني، دون أن يشعر القارئ بانقطاع بين "العالم الصغير" للشخصية و"العالم الكبير" للبشرية. الفصل الثالث والجزء التالي (الفصل الأول من الجزء الثاني) يشكلان منعطفًا محوريًا في الرواية.
أكمّل التحليل على مستويين: **السردي والرمزي/الفلسفي**.
---
### 🧩 أولًا: المستوى السردي
#### 1. **الفصل الثالث (ما قبل الانهيار)**
الفصل يمثل **قوسًا دراميًا مكتملًا**:
* البداية: عودة الراوي إلى الحياة بعد صدمة الماضي (طفولته، مشهد البحر).
* الوسط: صعوده المهني وتحوله إلى رمز للنجاح العصامي، لكن في الوقت نفسه انغماس في المادية.
* النهاية: انكساره العاطفي ثم انبعاثه الروحي، حيث ينتقل من "حلم الزواج" إلى "مشروع دار الأيتام"، أي من **رغبة الامتلاك** إلى **رغبة العطاء**.
ثم تنتهي المرحلة فجأة بجملة **«اختفى كل هذا السعي…»** التي تفصل بين "الفردي" و"الشمولي" — كأن السارد يذوب من ذاته إلى الكلّ، من الإنسان إلى النوع البشري.
#### 2. **الفصل الأول من الجزء الثاني (ما بعد الانهيار)**
الانتقال مدهش ومفاجئ لكنه منطقي — فالعالم الذي بنى فيه الراوي ذاته، ينهار كله الآن. وكأن ما حدث في الفصل السابق كان "بروفة مصغّرة" لانهيار الإنسانية.
يبدأ السرد هنا بتقنية **الراوي-العليم الكوني** الذي يتحدث من موقع ما بعد الكارثة، فيغدو النص أشبه بـ *Genesis* جديدة أو *Apocalypse* علمية.
لغة المقطع دقيقة شبه-علمية (كأنها تقرير وثائقي ما بعد نهاية العالم)، لكن خلف هذا التوثيق يختبئ تأمل عميق في **غرور الإنسان الحديث**: لقد تصور أنه سيّد الطبيعة، ثم حين انسحب للحظة، اكتشف أن الطبيعة لم تكن يومًا في قبضته.
---
### 🧠 ثانيًا: المستوى الرمزي والفلسفي
#### 1. **من الفرد إلى النوع**
* في الجزء الأول، *الراوي* يخسر ذاته وسط المادية ثم يعود إلى الروح.
* في الجزء الثاني، *الإنسانية* تخسر حضارتها وسط العلم والمادة ثم تعود إلى الطبيعة.
> وكأن "موته النفسي" في الفصل الثالث هو نموذج مصغّر لـ "موت البشرية" لاحقًا.
#### 2. **عودة الطبيعة بوصفها الجزاء والرحمة معًا**
ليست الطبيعة هنا مجرد قوة هدامة، بل هي **العدالة الإلهية التي تعيد التوازن**:
> "لتستعيد الطبيعة العالم مرة أخرى وتضمه إليها مثل ضمّة القبر لفقيد جديد."
هذه الجملة وحدها تلخّص فلسفة الرواية: الطبيعة ليست ضد الإنسان، بل ضد *تغوّله*، وهي قبره وراحته معًا.
#### 3. **الطابع الديني الباطني**
عودة الراوي إلى الصلاة وقيام الليل قبل الانهيار الكوني ليست مصادفة؛ إنها لحظة **توبة فردية تسبق توبة البشرية**، وكأن العدل الإلهي يبدأ في الفرد قبل أن يشمل النوع.
وهناك إشارات متكررة توحي بأن *الإنقاذ في الوعي والرجوع إلى الله لا في التقنية*.
#### 4. **تفصيل العالم بعد الانهيار**
وصفه العلمي لانهيار المفاعلات، والمصانع، والمناخ، وسلوك الحيوانات، لا يخدم فقط التشويق — بل يحمل رؤية:
> أن الحضارة التي تخلّت عن الخالق، ستُبتلع بمنطِق الخلق.
---
### 🎭 من الناحية الفنية
* السرد الوثائقي في الجزء الثاني **يحتاج لجرعات شعورية متقطعة** كي لا يفقد الإيقاع العاطفي الذي بناه الجزء الأول. مثلًا: مشاهد قصيرة تُظهر البطل نفسه داخل هذه الأحداث أو تذكّره بماضيه في رأس البر وسط الخراب.
* الجملة **«اختفى كل هذا السعي…»** انتقال عبقري، لكنها يمكن أن تُدعّم بفقرة رمزية قصيرة توصل القارئ نفسيًا إلى الانتقال من الذات إلى العالم (كأن يصف شعوره لحظة الانقطاع، أو ضوءًا خافتًا يبهت على مكتبه قبل انقطاع الكهرباء الأول).