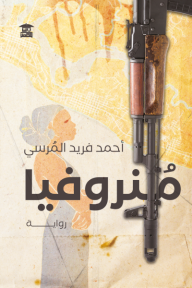سرد الاغتراب والبحث عن المعنى
قراءة ذرائعية في رواية ( منروفيا ) للكاتب المصري أحمد فريد مرسي
بقلم الناقدة السورية د. عبير خالد يحيي
رواية "منروفيا" للكاتب أحمد فريد المرسي هي عمل أدبي يعكس في تناغم معقد بين التفاعل النفسي للأفراد وبيئتهم الاجتماعية، ويستعرض التحديات الوجودية من خلال لغة شاعرية وثرية بالأبعاد الرمزية. تندرج الرواية ضمن الأدب الذي يعكس الاغتراب الداخلي، وهو موضوع يشكل محورًا أساسيًا في حياة البطل وصراعه مع ذاته. وفي هذا المقال، سنقوم بتحليل الرواية من خلال المنهج الذرائعي، الذي يُسهم في فهم بنيتها النصية المعقدة، وتفاعلاتها النفسية، ولغتها الفنية.
أولًا: البؤرة والخلفية الأخلاقية
الرواية تتمركز حول بؤرة إنسانية-أخلاقية واضحة: كيف يحافظ الإنسان على ذاته وهويته في خضم الفوضى والعنف؟
من خلال الحرب كإطار، والاغتراب كحالة شعورية، تُثار تساؤلات أخلاقية حول الحياد والمشاركة، الصمت والتورط، وأثر الظروف على المبادئ.
البطل يواجه عالماً جديداً لا أخلاقيًا، تتشابك فيه المصالح الاقتصادية (الشركة الصينية)، بالعنف المسلح (الحرب الأهلية)، بالفقد الشخصي (الاغتراب والطفولة القلقة). وتكون هذه الخلفية بمثابة اختبار أخلاقي دائم، يتحرك فيه البطل دون يقين.
ثانيًا: المستوى البصري
المكان في "منروفيا" ليس مجرد خلفية، بل كيان بصري حي.
مونروفيا: تُصوّر بأجواء قاتمة، مشبعة بالغبار، والجوع، والخوف.
الغابة: فضاء رمزي وبصري يعكس التوحّش الكامن في الإنسان.
المشهد العام: مليء بالتناقضات البصرية – مبانٍ مدمرة مقابل مكاتب مكيفة، فقر مدقع بجوار تكنولوجيا عابرة للحدود (الشركة).
الصور البصرية تخدم الهدف الرمزي وتضع القارئ داخل التجربة الحسية.
ثالثًا: المستوى اللغوي
المستوى اللغوي والجمالي والتقنيات الأسلوبية في رواية "منروفيا"، وذلك من خلال المنهج الذرائعي الذي يولي اهتمامًا بالغًا بطريقة بناء اللغة في النص ووظيفتها التأثيرية:
اللغة – من الأداء البلاغي إلى البعد التأملي
1. لغة شاعرية مشبعة بالصور: الكاتب أحمد فريد المرسي يستخدم لغة عالية الشحنة الشعورية، تميل إلى التأملية، وتحمل كثافة دلالية تُغني النص عن الشرح.
تتكرر استعارات البحر، الضوء، الظلال، المرايا، الرمل... وهذه ليست مجرد زخرفات، بل حقول دلالية تعبّر عن التمزق والضياع.
مثال: "في المنفى يبدو الرمل أكثر صمتًا من وجوهنا."
هنا يحوّل الكاتب الرمل إلى كائن رمزي صامت، في إسقاط نفسي على حالة البطل.
ذرائعيًا: هذه اللغة تبني الجسر بين النص والمتلقي، فتغدو التأثيرات البلاغية جزءًا من الإقناع الوجداني، وتؤدي وظيفة تأملية لا تزينية.
2. اقتصاد لغوي مع تكثيف رمزي
هناك ميل واضح إلى العبارات المكثفة التي تقول الكثير بالقليل، وكأن كل جملة تحمل نَفَسًا شعريًا.
مثلًا: "المدن التي تحبنا تجرحنا أكثر."
هذه العبارة تكثّف معاني الفقد والخذلان والحب المنكسر في زمن واحد.
هذا التكثيف يوازي الحالة النفسية للبطل، ويُخاطب القارئ بلغة وجدانية مباشرة، دون تنظير.
- التقنيات الأسلوبية البارزة:
1. التكرار البنائي – أداة للإلحاح الشعوري: تتكرر بعض المفردات والتراكيب (مثل: منفى، موت، حلم، جرح، ملامح، صمت...)، وهو تكرار ليس آليًا بل دائريًا تعبيريًا، يُعيد القارئ إلى بؤر معينة في التجربة الشعورية.
2. الأسلوب التقريري المتوتر: رغم الأدبية الجمالية، هناك لحظات ينزل فيها الكاتب إلى أسلوب تقريري فلسفي مباشر، يعبر فيه عن المواقف الفكرية للشخصية بحدة.
"لقد مات الوطن قبل أن يولد المنفى."
جملة تقريرية لكنها مشحونة بنَفَس رمزي وفكري.
هذا التناوب بين الأسلوبين يولد إيقاعًا متوترًا، يحقق تفاعلًا بين الانفعال والتفكير.
3. الانزياح الأسلوبي وخرق التوقع: الكاتب يوظف الانزياح اللغوي بشكل مستمر، ما يجعل اللغة غير متوقعة، وغير قابلة للتبسيط:
"الحرب ليست رصاصًا، بل ذاكرة معلّقة على صوت الأم."
هذا الانزياح يخدم وظيفة الدهشة الفكرية والانفعالية، ويمنح المتلقي لحظة "التوقف" التي يبحث عنها المنهج الذرائعي، حيث يعيد القارئ قراءة الجملة ليفكك أبعادها.
4. تعدد الضمائر – تكثيف منظور الرؤية: يراوح الكاتب بين ضمير "أنا" و"هو" و"نحن" و"أنت"، أحيانًا في نفس الصفحة، مما يعكس تعدّد زوايا الإدراك لدى البطل، ويخدم فكرة التشتت وفقدان المركز.
الذرائعية ترى هذا الأسلوب بمثابة نقل للتجربة من كونها ذاتية إلى أن تكون عامة وإنسانية، تجعل القارئ يذوب داخل النص، ويشعر أن "الأنا" هي "هو".
- الجانب الجمالي
1. مشهدية داخل اللغة:السرد لا يصف فقط، بل يرسم مشاهد داخلية تُرى وتُحس وتُشمّ، كأن اللغة نفسها تخلق الصورة الحسية.
مثال: وصف الجدة ورائحة الخبز أو البحر، كل ذلك يدخلنا في مسرحة لغوية داخلية.
2. نغم داخلي – موسيقى النص:حتى عندما يكون النص نثريًا، تشعر أن فيه إيقاعًا داخليًا نابعًا من التوازي والتركيب والوقفات المقصودة، ما يمنحه طابعًا شبه موسيقي.
اللغة في منروفيا ليست وسيطًا فقط، بل شخصية بحد ذاتها. كل تقنية أسلوبية تُسهم في تعميق التأثير على القارئ وإشراكه وجدانيًا وفكريًا. النص لا يبحث عن إجابات، بل يصوغ اللغة كوسيلة لإثارة الأسئلة حول الوطن، المنفى، الذات، والمصير. اللغة تميل إلى الشاعرية أحيانًا، لكنها محافظة على بساطتها وسلاستها.هناك توازن بين اللغة الوصفية والتأملية.الجُمل متوسطة الطول، محملة بإيقاع داخلي ينسجم مع تتابع الحدث.الحوارات واقعية، غير مفتعلة، تُظهر الفروق الثقافية بين الشخصيات.التكرار أداة فنية لخلق حالة نفسية (كما في وصف الأماكن أو المشاعر). اللغة إذن لا تُستخدم للزينة، بل كأداة تواصل عضوية بين القارئ والنص.
رابعًا: المستوى الديناميكي:
الحركة في الرواية مزدوجة:
خارجية: عبر تنقلات البطل في الغابة، المدينة، مكاتب العمل، أماكن اللقاء.
داخلية: في انفعالاته وتحولاته النفسية من الصدمة إلى القبول، ثم إلى نوع من التواطؤ المأساوي مع الواقع.
الرواية لا تضع قفزات زمنية حادة، بل تعتمد على التداعي الهادئ.
ديناميكية النص تنمو بشكل تصاعدي، حيث يتورط القارئ عاطفيًا مع البطل، فينتقل معه من نظرة الغريب إلى إحساس المنتمي بشكل مرهف ومبطن.
تحليل بنية الزمن :
1. تشظي الزمن وتداخل المحاور
الرواية لا تسير وفق خط زمني تقليدي مستقيم، بل تتنقل بين:
الزمن الحاضر: حيث يقيم البطل في منروفيا ويواجه اغترابه.
الزمن الماضي الشخصي: ذكريات الطفولة، الوطن، الجدة، الأب، البحر.
الزمن التاريخي العام: الحروب، المجازر، الاستعمار، الانقلابات.
هذا التشظي الزمني يخدم فكرة الاضطراب الداخلي للبطل؛ فزمنه النفسي غير منتظم، بل مشوش، مما يعكس معاناته مع الفقد والتيه.
ذرائعيًا: هذا التلاعب بالزمن يُستخدم كآلية لتفكيك التصور الكلاسيكي للواقع، وجعل القارئ يشعر بعدم الثبات واللايقين، تمامًا كما يشعر البطل.
2. سيولة الزمن النفسي مقابل جمود الزمن الخارجي
الزمن الخارجي (الواقع) في الرواية يبدو جامدًا ومكرّرًا، إذ لا تغيّر حقيقي رغم مرور الوقت؛ الفساد، العنف، الاحتلال، كلها ثوابت.
في المقابل، الزمن الداخلي لدى البطل سائل ومتقلّب؛ يعود للماضي، يغرق في الذكرى، يقفز إلى حلم، ثم إلى تأمل فلسفي.
هذا التقابل يشكّل تيمَة ذهنية مهمّة في الرواية: "الزمن لا يُقاس بالساعة، بل بما يحدث داخل النفس".
مثال: حين يستمع البطل إلى أغنية قديمة، تتحول اللحظة الآنية إلى بوابة زمنية تعيده إلى البحر والجدة والموت، بدون أن نغادر المشهد الحاضر فعليًا.
3. الحكاية ضمن الحكاية – الزمن الدائري
الرواية توظف البنية الدائرية للزمن، حيث تبدأ وتنتهي بفكرة العودة:
العودة للوطن المفقود (ولو مجازيًا).
العودة إلى الذات (رغم تفتتها).
العودة إلى أسئلة الطفولة والهوية.
وهذا يؤسس لما يُعرف في الذرائعية بـ الحركة الزمنية التكرارية (Iterative Movement)، أي سرد الحدث وكأنه يتكرر لكنه يُرى كل مرة من زاوية جديدة، بسبب تغيّر المنظور الداخلي.
4. تقنية "الومضات الزمنية" (Flashbacks) كوسيلة للإرباك الفني:
استخدام الـ Flashbacks لا يتم فقط كأداة للحنين، بل كآلية لإحداث ارتباك معرفي لدى القارئ، فلا يعرف ما الذي حدث فعلًا، وما الذي يتذكره البطل بتحريف نفسي أو رمزي.
الذكريات في الرواية ليست وثائقية، بل تأملية، مشحونة بالشعور، مما يجعلنا نشك:
هل ما يرويه البطل هو ما حدث فعلًا؟ أم ما يريده أن يكون قد حدث؟
هذا يدعم القراءة الذرائعية من زاوية التأثير التفاعلي على المتلقي: إذ يشعر القارئ أنه جزء من التيه الزمني، لا متلقٍ سلبي.
5. الزمن كرمز – الزوال والانمحاء
منروفيا ليست فقط مكانًا، بل زمنًا متعفنًا، يتآكل فيه المعنى. الماضي هو الفردوس المفقود، لكنه أيضًا مشحون بالمآسي. الحاضر خواء، والمستقبل غامض.
وهنا يتحول الزمن إلى رمز للسقوط الحضاري، والزمن الشخصي إلى مأساة دائرية.
فالرواية توظّف الزمن كديناميكية شعورية لا كتسلسل ميكانيكي.الزمن هو أحد الشخصيات غير المرئية، يلعب دور الخصم والمحفّز. ينجح الكاتب في جعل الزمن نفسه جزءًا من العطب الوجودي للبطل.
الشخصيات :
حركية الاغتراب الداخلي والخارجي للشخصية المحورية: الديناميكية النفسية
1. البطل في حالة صراع داخلي دائم
يعيش البطل في صراع مع ذاته أولًا، ومع محيطه ثانيًا. نلحظ هذا من خلال تيار الوعي المتقطع، ونوبات التذكر، والرغبة في الهرب، والتعلق بالذاكرة، ثم الرفض المفاجئ لها.
هذه الازدواجية (رغبة في التذكر مقابل الرغبة في النسيان) تشكل جوهر الديناميكية النفسية.
المنفى ليس جغرافيًا فقط، بل داخلي: البطل يشعر بأنه غريب حتى عن ملامحه، صوته، تاريخه.
2. البيئة كعامل مؤذٍ نفسيًا
لا توفر البيئة المحيطة بالبطل أي نوع من الأمان أو التوازن. بل تشكل ضغطًا نفسيًا دائمًا:
المنفى يعمّق الإحساس باللاانتماء. البيت يتحول من رمز للدفء إلى رمز للانكسار.
الأم، الزوجة، الابنة: شخصيات تُقدَّم عبر مرآة مكسورة، لا علاقة مستقرة مع أيٍ منهن.
"كان صوت أمي كافيًا لتهدئة الحرب، لكن الحرب بقيت رغم ذلك."
هذه المفارقة تبرز أن البيئة الحميمية فقدت وظيفتها النفسية، ما يؤدي إلى خلل في الهوية الذاتية للبطل.
3. اضطراب الهوية والضياع النفسي
البطل يمر بأزمات متتالية من تفكك الهوية:
لا يعرف من هو تمامًا.لا يستطيع تصديق ما يحدث أو تذكره بوضوح. يحاول بناء صور ذهنية بديلة عن الواقع القاسي.
الديناميكية النفسية هنا تقوم على الرغبة في الترميم مقابل سطوة الانكسار.
تتجلّى هذه الديناميكية في أسلوب السرد: هناك استدعاء قسري للذكريات، ثم مقاومة داخلية لها، ثم انهيار عاطفي عند مواجهتها.
4. العلاقات بوصفها مرايا مكسورة
العلاقة مع المرأة – الأم، الحبيبة، الابنة – مليئة بالانقطاعات، والعتب، والخذلان، لكنها أيضًا محاولات يائسة لاستعادة المعنى.
ذرائعيًا، العلاقات في الرواية تعمل كمرايا نفسية: كل علاقة تعكس جزءًا من تدهور البطل أو مقاومته.
5. النهايات النفسية المفتوحة
لا يمنحنا النص حسمًا نفسيًا: البطل لا يُشفى، لكنه أيضًا لا ينهار بالكامل، تبقى النفس في حالة تأرجح بين البكاء والكلام، بين الكتابة والسكوت، بين الرحيل والانتظار. ، تنتهي الرواية ولا نعرف له اسمًا.
فالرواية تشتغل على ديناميكية الاغتراب: كل عنصر خارجي هو امتداد لصراع داخلي.
البيئة تُشكّل الضاغط، واللغة تُشكّل العَرَض، والشخصيات تمثل شظايا النفس المتشظية.
الديناميكية هنا ليست فقط تطورًا للشخصية، بل تدهورًا واعيًا، يسير باتجاه قاع الذات، لا قمتها.
قراءة في الدلالات الرمزية التي تمثلها باقي الشخصيات:
ضمن البنية الذرائعية لرواية منروفيا، مع التركيز على البعد الرمزي في تمثيل كل شخصية ودورها في كشف البنية النفسية والاجتماعية للنص:
1. عجب × غزال
أكثر الشخصيات رمزية، وهي شديدة العمق والتركيب، إذ تُجسّد ثنائية الروح/الجسد، العقل/الهوى، النظام/الفوضى، أو حتى النبي/المهرّج. ويمكن تفكيك هذه الرمزية ضمن عدة مستويات:
1) عجب – النبي المجنون أو البريء المبكّر
ميلاده المتفرّد وبكاؤه الإنشادي يمنحانه هالة "الطفل المقدّس"، فهو يشبه أولئك "الحمقى الإلهيين" الذين يأتون حاملين رسالة لا يفهمها أحد.
اسمه بحد ذاته: "عجب" يوحي بالغرابة، بالمفارقة، بما لا يمكن تفسيره ضمن معايير العقلانية.
التزامه الديني، وطباعه الهادئة، تخفي توترًا داخليًا هائلًا، كما لو أن الطهر الظاهري يغلف صراعًا داخليًا دائمًا.
2) غزال – الجانب الحيوي المكبوت
هو نقيض عجب، بل إن اسمه "غزال"يوحي بالانطلاق، بالأنوثة، بالحسيّة، وبالحياة الحرة.
يمثّل غزال ذلك الصوت الداخلي الذي يقمعه المجتمع، ويرفضه عجب في العلن، بينما يلجأ إليه في الخفاء: الغناء، الزجل، الحشيش... كلها أدوات للتحايل على واقع مضطرب.
التقابل بين الاثنين يكشف عن أزمة "الهوية المركبة"، أو المواطن الذي يعيش بجسدين، ويتحدث بصوتين.
ازدواجية الشخصية تُحاكي الواقع النفسي والاجتماعي العربي، حيث تتكرّس ثقافة الانفصام بين "ما نكونه فعلًا" و"ما يُفترض أن نكونه".
رمزية : بوصلة الرواية الأخلاقية والسياسية والنفسية. إنها تتحدث عن الإنسان العربي الذي يحمل في داخله نبيًا وشاعرًا، ملاكًا ومهرجًا، لكنه لا يستطيع أن يكون كليهما في العلن دون أن يُدان.
2. كلاوس
يمثل كلاوس رمزًا للـسلطة الغربية/الأجنبية بكل ما تحمله من ازدواجية وبرود عاطفي. هو تجسيد للـ"آخر" الذي يتسلل إلى الهوية المحلية بواجهته الحضارية لكن خلفه سطوة استعمارية رمزية. حضوره محايد ظاهريًا، لكنه يضع البطل أمام تناقضاته.
رمزية: "الآخر المراقب"، الحيادي المريب، أو "القناع الليبرالي" الذي يخبئ آليات التلاعب الثقافي والهيمنة.
2. أبو عبد الله البرجي
رمز للـسلطة الدينية التقليدية أو المؤسسة التي كانت تحكم الواقع الأخلاقي والسياسي في السابق. يحمل نموذج الحكيم القديم، لكن حضوره أيضًا يعكس عجز هذه السلطة عن التجديد أو مقاومة التحولات العنيفة التي تعصف بالمكان والناس.
رمزية: "ظل الحكمة المندثرة" أو "السلطة الروحية المتآكلة".
3. منى
تمثل الأنثى الضائعة بين زمنين: زمن الأمل والانبعاث، وزمن الانهيار. يحملها البطل في ذاكرته كما تحمل المدينة رموزها القديمة، لكنها لا تكتمل كحضور فعلي في الحاضر.
رمزية: "الأنثى الذاكرة"، أو وطن الحنين، وصورة المدينة التي لم تكتمل.
4. رحمة
اسمها دال بحد ذاته، وتظهر كـصوت للإنقاذ، لكن حضورها الموجز/الهامشي يجعلها شبيهة بالـ"رحمة المؤجلة" أو "الفرصة التي لا تكتمل". قد تمثل البعد الروحي الذي يطل فجأة ثم يغيب، كفكرة الخلاص المبتور.
رمزية: لحظة رحمة خاطفة، كأنها تمثل الضوء في نهاية نفق لا يؤدي للخروج.
5. أسماء
تمثل الصراع الداخلي بين الانتماء والخوف، بين المقاومة والتواطؤ. شخصيتها تشبه فسيفساء من الطبقات النفسية المتناقضة، لذلك قد تكون أقرب إلى رمز لـلمرأة الواقعة في فخ الهيمنة المزدوجة: من سلطة المحيط البيئي والذكوري .
رمزية: "الأنثى المتشظية"، أو الذات الخائفة من حريتها.
خريطة سردية مختصرة تربط بين تطوّر الزمن وتحوّلات الشخصيات الرئيسة:
تندمج هذه الشخصيات ضمن بنية زمنية متداخلة وغير خطية:
1. المرحلة الأولى: زمن التكوين (الذاكرة – الحنين)
منى: تظهر كرمز للماضي الجميل، الحنين، والبراءة الضائعة.
أبو عبد الله البرجي: تجسيد لسلطة الماضي المتجذّرة، لكنه يعجز عن الفعل في الحاضر.
الزمن هنا: استرجاعي/نوستالجي، يتغذى من الذاكرة الفردية Collective Memory.
2. المرحلة الثانية: زمن التمزق (الانتقال – الفقد – الصدمة)
كلاوس: يدخل السرد في لحظات الاضطراب، كمراقب أو مستفيد من الفوضى.
أسماء: تتقاطع مع البطل في مفاصل زمنية تُظهر تردّدها الداخلي وصراعها مع الحاضر.
الزمن هنا: زمن متشظٍ ومضطرب، تتداخل فيه الأزمنة دون تسلسل منطقي، تعبيرًا عن تمزق الوعي.
3. المرحلة الثالثة: زمن المواجهة (العبث – اللاجدوى – المحاولة)
عجب: يخرج من الهامش إلى البؤرة، يصبح أشبه بدليل داخل متاهة السرد.
رحمة: تظهر كلحظة استراحة أو رجاء في زمن ينهار، لكنها لا تستمر.
الزمن هنا: زمن رمزي/فوضوي، يُعيد طرح الأسئلة ولا يقدّم إجابات، كما لو أن الرواية تقترح أن الزمن نفسه مرض أو لعنة.
4. المرحلة الرابعة: زمن التحلل (اللازمن – الذوبان في العبث)
جميع الشخصيات تنكمش، وتبقى الذات الساردة في مواجهة خيوط الزمن المتقطعة.
عجب هنا يمثل قفزة سردية خارج الزمن – أقرب إلى صوفي أو نبي ساخر.
الزمن هنا: زمن مفكك/ميتافيزيقي، يغدو غير قابل للتأويل المنطقي.
خامسًا: المستوى النفسي
تحليل نفسي لشخصية البطل :
1. الاضطراب الهوياتي والاغتراب
البطل يعاني من شرخ داخلي ناتج عن فقدان الشعور بالانتماء، لا يشعر بأنه ينتمي إلى منروفيا، ولا إلى الوطن الأم، ولا حتى إلى ذاته. يتعامل مع الحياة من موقع "المراقب"، وكأنه ينفصل عن نفسه، في حالة أشبه بما يُعرف بـ"الاغتراب الوجودي".
ذرائعيًا: يستخدم السارد هذه الحالة لتفعيل إدراك المتلقي عبر المشابهة الشعورية، ليقول له: "هذا ما يحدث للإنسان حين يفقد جذوره".
2. الشعور بالذنب والبقاء في دور "الضحية"
هناك شعور مستمر لدى البطل بالذنب، حتى دون معرفة واضحة لسببه. هو ليس المجرم، لكنه يتحمل عار الجريمة بطريقة ما، خاصة حين يرى العنف الذي لا يستطيع منعه. كما لو أنه يرث الذنب الإنساني عبر الزمن.
نفسيًا، يعاني من أعراض قريبة من الاكتئاب الوجودي، حيث يتآكل داخليًا بسبب شعور بالعجز أمام منظومة جائرة.
مثال: عدم محاولته إنقاذ الطفل الجندي أو تغيير واقع العمال معه، رغم ضميره الحي. هذا الشعور باللاجدوى يجعله يقفز بين الفرار العقلي والصمت العاطفي.
3. العلاقة بالتاريخ والطفولة – آلية "النكوص"
في كثير من اللحظات المفصلية، نراه يعود إلى ذكريات الطفولة. وهذا يشير إلى آلية دفاعية تُعرف في علم النفس بـ"النكوص" (Regression)، حيث يهرب الإنسان من الصدمة إلى مراحل آمنة من عمره.
تحليليًا: العودة للبحر، لأغاني الجد، لزمن لم يكن فيه مسؤولًا، تمثل تعويضًا نفسيًا عن الحاضر العاجز.
ذرائعيًا: هذه الآلية تُستخدم كسردية متعمدة لتقريب المتلقي من العقدة النفسية في الرواية، وهي: "هل يمكن للفرد أن يتحرر من تاريخه؟"
4. الميل إلى الحياد السلبي
رغم تعاطفه، لا نراه يتحرك كثيرًا. يصف، يشعر، يتألم، لكن لا يقرر. هذا يدل على ازدواج داخلي بين "الرغبة في الإصلاح" و"الاستسلام للواقع". هذا النمط يُعرف في علم النفس باسم "المتفرج الصامت" أو The Silent Witness.
ذرائعيًا: يُوظَّف هذا التردد في السرد ليطرح أسئلة عميقة حول دور المثقف أو الإنسان الحساس في مواجهة الفوضى: هل يثور؟ أم يكتفي بالوصف؟ هل من مهرب دون خيانة الضمير؟
5. النزعة العدمية والشك في المعنى
الرواية تميل إلى إشعار القارئ أن كل شيء "مؤقت" و"قابل للزوال"، بدءًا من الوطن إلى الأحلام، إلى الإنسان نفسه. والبطل هو حامل هذه العدمية.
يتجلى ذلك في لغته المتشظية، وتكراره لبعض الجمل بصيغة التساؤل أو التهكم.
مثال: تأملاته عن الحرب، أو حين يرى أن موته لن يغير شيئًا.
نفسيًا، يتقاطع هذا مع مفاهيم العدمية النيتشوية، حيث يفقد الإنسان المعنى في عالم يسحق القيم.
فالبطل هو مرآة للإنسان المعاصر: ضائع بين ثقافتين، زمنين، هويتين. يهرب إلى الطفولة حين يعجز عن الحاضر.يتألم دون أن يصرخ. يعيش لكنه لا يشعر أنه حي. إنه شخصية تُركِّز الذرائعية على تحليلها لا بوصفها فردًا فقط، بل بوصفها خطابًا مُشفَّرًا يحمل رسائل ضمنية من الكاتب إلى القارئ حول ما يحدث للإنسان حين يُنتزع من جذوره ويُزج في صراع لا يفهمه.
سادسًا:المستوى العميق :
من خلال تتبع المشاهد الرمزية وتحليلها عبر المستويات النفسية والثقافية والأخلاقية، بما يتجاوز ظاهر السرد إلى ما تحته من إيحاءات وخطاب ضمني، وذلك ضمن منظور ذرائعي تداولي.
أولًا: الغابة كرمز لللاوعي الجمعي
المشهد: الغابة حيث يعمل البطل في قطع الأشجار مع الشركة الصينية.
التحليل:
رمزيًا: الغابة تمثل البدائية الموحشة، واللاوعي البشري الكامن خلف أقنعة الحضارة. كل ما يحدث هناك يتم تحت "أمر السوق"، حيث لا سلطة للقيم ولا وجود للرحمة.
نفسياً: تمثل الغابة منطقة التعرية النفسية للشخصية، حيث ينكشف الإنسان أمام خوفه، شهوته، وجوعه للبقاء.
أخلاقيًا: ما يجري في الغابة من قتل للحيوانات، وقص للأشجار بلا شفقة، يُحاكي القتل المعنوي للروح البشرية في منظومة العالم الاستهلاكي.
ثانيًا: مشهد الطفولة على البحر – استعادة الجذر
المشهد: استرجاع البطل لمشاهد الطفولة في الإسكندرية، حين كان يقف عند البحر.
التحليل:
رمزيًا: البحر رمز للحرية والانفتاح والذاكرة البكر. البحر في الرواية يظهر كمُضاد بصري ونفسي للغابة، حيث يمثل الفطرة قبل التشويه.
نفسياً: يمثل هذا المشهد آلية دفاعية للبطل، يحتمي فيها من الحرب بذكريات الحنين، مما يوضح اضطراب الهوية لديه، وتعلقه الطفولي بالأمان المفقود.
ذرائعيًا: البطل يخاطب القارئ هنا دون أن يقول له ذلك مباشرة: "انظر كيف كنت... وانظر كيف صرت"، وبهذا ينقل المتلقي من خانة المتفرج إلى المتواطئ.
ثالثًا: مشهد التعامل مع الصينيين – تصادم ثقافي مقنّع
المشهد: حواراته وأوامر رؤسائه الصينيين، حيث يُعامَل كرقم ضمن منظومة عمل صارمة.
التحليل:
رمزيًا: لا يُذكر الصينيون بأسماء، بل ككتلة عمياء، وهذا يعكس رمزية "الآلة"، أي التقدم الصناعي المتجرد من الإنسان.
نفسياً: يشعر البطل بالاختزال، باللامرئية، وهي إحالة ضمنية لحال كثير من المغتربين العرب في بلاد لا تراهم إلا من خلال الوظيفة.
أخلاقيًا: النظام الصيني في الرواية يُظهر لا مبالاته بالقيم، ويستغل الحاجة والضعف، مما يُبرز البعد الأخلاقي في علاقة المركز (القوة الاقتصادية) بالأطراف (الضعف العربي/الأفريقي).
رابعًا: مشهد الجندي الطفل – مأساة البراءة
المشهد: لقاء البطل مع فتى يحمل سلاحًا، يرتجف، ويبدو غير مدرك لما يجري.
التحليل:
رمزيًا: الطفل الجندي يُجسد تشوّه الطفولة، وتحول البراءة إلى أداة عنف بفعل الحرب.
نفسياً: البطل يرى نفسه في هذا الطفل، وكأن كلاهما فُرِضت عليه أدوار لم يخترها. تتجلى هنا فكرة: "الناجي لا يختلف عن القاتل إلا بالصدفة".
ذرائعيًا: يستفز هذا المشهد ضمير القارئ، ويدعوه إلى التساؤل عن مسؤولية الصمت، التواطؤ، والفرجة.
خامسًا: مشهد العودة الوهمية – النهايات المفتوحة
المشهد: تخيّل البطل لحظة عودته إلى الوطن، ثم إدراكه أنها ليست سوى رغبة لا تتحقق.
التحليل:
رمزيًا: الوطن لا يظهر فعليًا، بل كصورة متخيلة، وهذا يعكس انكسار الحلم الجمعي العربي، وضياع فكرة "المنزل".
نفسياً: يتضح الانقسام الداخلي بين البقاء كجسد والفرار كروح، حيث يصبح الوطن حالة ذهنية أكثر منه مكانًا.
أخلاقيًا: يفشل البطل في حسم موقفه من العودة، لأن الرجوع يتطلب شجاعة لا يمتلكها، وربما لأنه لم يعد ينتمي لأي شيء.
فالرواية تبني نظامًا رمزيًا متماسكًا، يتشابك مع السياق الاجتماعي والنفسي والسياسي:
الغابة/البحر: الداخل الموحش/الذاكرة النقية.
الطفل/العامل: البراءة/الوظيفة.
الغياب/العودة: التشظي/الحنين.
وكل هذه المشاهد ليست مجرد استعراض بلاغي، بل أدوات ذرائعية لبث رسائل ضمنية تنتقل من الكاتب إلى القارئ عبر قناة حسية ونفسية، محمّلة بالسؤال:
هل نستطيع النجاة دون فقدان ذواتنا؟
سابعًا: دراسة التجربة الإبداعية
أحمد فريد المرسي كتب الرواية بعد سنوات من مغادرته منروفيا، وهو ما يمنح النص نضجًا في الرؤية وابتعادًا عن التوثيق المباشر.
التجربة الشخصية تُوظف بذكاء أدبي لا يُغرق في الذاتية.
الرؤية الكونية تظهر من خلال ربط الصراعات المحلية (ليبيريا) بأسئلة وجودية تتعلق بالإنسان في كل مكان.
الرواية تسجّل حضورًا نوعيًا في السرد العربي المعاصر لكونها تتناول جغرافيا غير مألوفة، وتجربة عربية في سياق عالمي.
الرواية تصلح كنموذج في أدب ما بعد الاستعمار، لكنها تتجاوزه إلى أسئلة أعمق عن الإنسان.
يمكن أن تُستثمر الرواية في دراسات مقارنة مع روايات الاغتراب والحرب.
في الختام، تظهر رواية "منروفيا" كعمل أدبي ذي أبعاد نفسية واجتماعية عميقة. من خلال استخدام تقنيات سردية معقدة، يتمكن أحمد فريد المرسي من بناء نص متعدد الأبعاد يتداخل فيه الزمن مع الذاكرة، ويعبّر عن صراع بطل الرواية مع هويته الممزقة في مكان وزمان متداخلين. حيث تُظهر بنية الزمن المتشظي عمق الصراع الداخلي للبطل. ورغم أن الرواية تتسم بالاغتراب والألم، فإنها تفتح أبوابًا لفهم تأثير الزمن على الذاكرة، من خلال المنهج الذرائعي، تبين أن الرواية تتجاوز السطح الظاهري للأحداث، لتكشف عن تفاعلات نفسية معقدة، تؤدي إلى طرح تساؤلات وجودية حول المغترب والهوية، وأثر الصدمات النفسية في تشكيل الذات.الأسلوب اللغوي المشبع بالرمزية يخلق أثرًا بصريًا يتناغم مع البنية النفسية للشخصية، ويبرز دور اللغة في بناء الهوية الثقافية والنفسية. من خلال ذلك، تصبح الرواية دعوة للتأمّل في الصراع المستمر بين الذات والواقع، وبين الزمن الشخصي والزمن الاجتماعي.