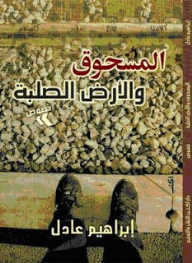المسحوق والأرض الصلبة: نصوص محلّقة في فضاء راقص!
أودُّ لو أمنح هذا الكتاب خمس نجوم/ لكنني أؤمن دوماً بأن: لا اكتمال في الأدب/ دوماً هناك ثقب ما/ ثغرةٌ ما، لذلك ضغطت على الرقم الأكثر قرباً من الاكتمال! قد أبدو متواطئة/ "غوّازة"/ منحازة / مجامِلة زيادة عن اللزوم... سمها ما شئت صفني بما شئت واسترسل في التسميات/ الصفات، فأنا أعلم أنني لستُ كذلك خذ ما سأقول عن هذا الكتاب:
ذنبه الوحيد (هذا الكتاب) أنني كنت أدّعي - بينما كنت أقرأه - أنني أعرف مؤلفه، أشعر أن هذا الكاتب صديقي، يتلصص عليّ يحاول حتى أن يأخذ من عقلي كل ما أفكر فيه فيدونه، كأننا في سباق مع الحروف، أو كأننا في فحص فكريّ!
الآن أجري وراء الكلمات بينما أحاول أن ألتقط كلمات تصفُ حقيقة ما قرأت في هذا الكتاب (الأدبيّ/ الشفاف/ الصريح/ العميق) فكل ذلك أتقنه فيه المؤلف بامتياز، لا أود امتداح الكتاب بأكثر من جملتين هما: مفردات نصوصه واضحة، وتحت كل مفردةٍ منها يختبئ مخزنُ معانٍ! أنا لا أريد أن أمتدح الكاتب ولا الكتاب لكن ماذا عساي أفعل إن كان مجرد وصف الكتاب، أو القراءة فيه هو امتداح بكل ما في كلمة المدح من معان!
فكرت قبل أن أمسك بالكتاب أن لماذا عنون الكاتبُ كتابه بهذا العنوان؟ ولماذا مسحوق وأرض صلبة؟ أليسَ الأليق بالمسحوق هو الفضاء؟ - على اعتبار أن المسحوق يشبه ما يسمى بالبودرة البيضاء التي اكتشفت خلال القراءة أنها ليس إلا مسحوق ولكنه من الفلفل الأسود! - وقبل أن أسرح بخيالي أجدني أصطدم بصورة الغلاف، أحدق: أحجار متكسرة وقدمان، يبدو أن شخصاً ما ينظر من علوٍ شاهق إلى سفولٍ سحيق، بينما أكرر النظر فلا أرى في الصورة إلا ردماً لمدينة الحلم المشهود وثمة شاهدي قبرين، وأسرح عبر الصخر المتكسر، أتساءل بأسى كأن القبرين لبقية أهلي: لمن هذا القبر.. والآخر.. لمن يا ترى... وبكل الأحوال لم أجد إجابة، بالحق... أتظاهر أنني لم أجدها!
أول ما تعثرت به بيانات الكتاب، وسنة النشر والناشر وأشياء مختلفة؛ لأشعر بغيرة لا أعلم لها سبباً حين رأيت النقاط في آخر صفحة الإهداء بعد كلمة: (وإلى)!
لم أقرأ النصوص متقطعة ومبعثرة وحسب قائمة المحتويات أو (الفهرس) – كما أفعل غالباً - بل قرأته بالتتالي: الأول فالثاني ... الخ. في بداية الكتاب وجدت الكاتب يخبرني عن سبب تركه المجال مفتوحاً والمدى معه والتصنيف كذلك، وابتعاده عن وسم نصوصه بلون واحد – هذا أول سبب جعلني أدّعي أنني أعرف الكاتب وأنه يتلصص على عقلي ويستعمل أفكاري – فشعرت للحظة أنه مثلي ربما، يترك العنان لقلبه وقلمه ليمرحا فيسكب إحساسه بدوره ليكتباه دون أن يحسبا حساب الألوان، فالمهم أن يصل الإحساس. وحينها قررتُ أن أكمل كما بدأت بالأنفاسِ المتلهفِة ذاتها، بالرغبةِ المتقدة إياها، ووجدتني أستمر بينما تزيدان!
لم أحب اللهجة العامية التي كانت تقطع اتصالي المباشر بالنصوص أحياناً إذ أنني في حالة التجلي مع الفصحى لا أحب أن تصادفني نصوص كاملة باللهجة العامية إلا أنها ولا شك كانت تمدني بنكهة مختلفة ولذيذة إلى حد ما؛ حال القراءة نكهة تشبه قطع التهام كتاب فكريّ بنكتة مضحكة مبكية. وبين لحظة وأخرى. وشوقاً إلى ما يلي كنت أحاول أن أسرع في القراءة وألاحق نفسي وأنفاسي لأقرأ ما تلا، لكنني كنت أجدني فجأة أعود للبطء والراحة في القراءة من جديد، وأجدني في بعض الأوقات مضطرة لقراءة الجملة أكثر من مرة – ليس لأنها صعبة بل لأنني شردت! - ففي كل مرة تصلني فكرة جديدة. وعلى الرغم من بساطة الكاتب وقربه منك حين يحدثك – تلك الميزة أيضاً جعلتني أشعر أنه استعمل إحساسي وأسلوبي حين استخدمها – تجد أنك تتحاور، لا تتلقى فحسب. تشابهنا في بعض المصطلحات والأفكار وتقاطعات الحياة، والطريق التي نختارها إن وجدنا أنفسنا على مفترق طرق، في الحديث عن الأشياء والقيم والمفاهيم، وربما في طريقة الالتهام، والحديث مع الأصدقاء، في توثيق اقتباساته والأغنيات المضمنة، وحتى في استخدامات علامات الترقيم، تعلمون طبعا أنني لا أفكر للحظة في أن شيئاً من هؤلاء هو ملكٌ لي، إلا أنني للحظة وكما أخبرتكم قبلاً/ أدّعي أنني صديقة الكاتب، وأننا نعرف بعضنا.. أو هكذا خيل إليّ.. فجعلني أشعر بحالة تشبهُ السطو على أشيائي حين كنت أقرأ له.
أشعر أنني أعايشُ كذبة إبريل. حين أفكر للحظة في أن هناك رجلٌ ما على بقعة ما من تلك الكرة الأرضية يشبهني أنا ولو قليلاً جداً إلى حدٍ لا يكاد يظهر/ ثم إنني أود لو أنني أقرأ الكتاب الآن مرة أخرى لآتي بكل ما أعجبني. بكل ما فاجأني، كل ما أدهشني، وكل ما وجدتني في تفاصيله، لأبرهن أو ربما لأنني أشعر كما قلت ذات مرة في بيتين شعريين:
بيني وبين المبدعين قرابةٌ :: لا في دمٍ حتى ولا ببلادِ
هي وحدةُ الهدف النبيل يشدنا :: نحو السماء فنرتقي بجلاد
أسترسلُ في القراءة ويشدني نص ويفلتني آخر، ويمسك بتلابيبي عنوان ولا يلفت انتباهي آخر، شيءٌ للأب وشيئان للحبيبة، ثم نص نقدي فنصانِ عاطفيان (العاطفة المثقوبة التي سأحدثكم عنها بعد قليل) يلي ذلك نصان متتاليان للقيم ثم (طفرة) نص ثالث للمفاهيم، ورابع وخامس.. أعيد قراءتهم كتلةً واحدة فأجدُ أن واحدهم لا يخلو من ذكر الحبيبة. أكاد أحلفُ لنفسي: أن الكاتب حين كتب تلك السطور لم يكن يعيش قصة حُبّ، وأقنع نفسي بالخيبة التي سأشعرها إن كان تخميني ليس في محله، ثم أعود لأقول: هذه قناعة؛ ليس هناك حبيبة وأقسم على خيالي أن يصدق، وأعود لأفتح الموضوع أخرى لأسلّم أخيراً: يوجدُ قصةُ حبٍ، لكنها لن تكتمل!
أما عن العاطفة المثقوبة؛ تحدث الكاتبُ كثيراً حتى أنني كنت أشعر أنه يتلعثم بينما أغمضُ عينيّ ويسردُ عليّ الأحداث، يحاول أن يلتفّ حول الحدث الحقيقيّ ليخبئ انكساراً ما خلف النقاط العديدة التي كرهتها، أو أكاد أكرهها! أو خلف القفز إلى تاريخ آخر بحكاية أخرى لأصرخ حانقة: "ما ذنبي - كقارئة وليس كشاعرة – لتجعلني أتوه في زوايا حياتك" لكنه في كثير من مواضع اقتباسه من شعر أصدقائه والكتاب الكبار و(التناص) الذي نحاه أحياناً خلال سرده البسيط جداً/ العميق جداً، السهل جداً/ الممتنع جداً... جعل دمعة تتدحرجُ على خدي ليس لأنه مؤلم، ولا لأنه معجز بل لأنه صادق، وصادق حد اللا تصديق! لأن نصوصه تفرد نفسها أمامك، تغريك، تجعلكَ تشعرُ أنها متاحة، أنها ملكك، أنها سهلة وأنها لن تتعبك، لتفاجئك تلك النصوص المحتالة، بتمنعها الذي يعجزك أحياناً فتهرب لخيالك وتكتب فيه نهاياتٍ ما، أو تخرجَ القصة بشكل يليق بمستوى التشبع الذي وصلت إليه (شخصياً أعجبني مصطلحا: نحاه، وتناص)
كان هناك سدّ ما يقف بيني وبين بعض الأفكار التي وصل إليها خيالي بينما كنتُ أقرأ الكتاب، لكن كلما شردت جاء بي أي مصطلح غريب استخدمه الكاتب وجعلني أسأل نفسي: لماذا استخدم المؤلفُ هذا المصطلح؟ لكنني أشهدُ أن الكاتبَ لطيف / مهذب – حتى نهاية الكتاب على الأقل – يظن نفسهُ أحياناً مفترساً كأسد/ جارحاً كصقر مثلاً لكنك تعلم كم هو أليف، وديع كطفلٍ بعينين أخاذتينِ مع أنه ظن نفسه في بعض الأحيانٍ كهلاً، ما زاد حيرتي تعقيداً أنه لم يعترف أبداً أنه شاب! لقدْ ذكرني بمصريّة (صلاح جاهين) الأصيلة، السمراء، البسيطة، المكتظة بالأشياء! وكان قريباً جداً/ معك أينما سرحت بعينك وقلبك.. تشعر أنه صديقك حين يزيد أكثر من حرف مدّ في الكلمة "طشااااااش" أو "يدووووور" / "تروووووح" أو "آآآآآه" التي كنت أود حين أقرأها أن أصرخ: هذا لا يجوز، ليقف خيالي في وجه اعتراضي أو انتقادي قائلاً: تتركين كل هذا الجمال وتعترضين على ما يجب أن تسلّمي به: أن الكاتب يبدو أكبر عمراً – افتراضياً – من تاريخ الكتابة (الحديثة على الأقل!) كذلك كان ينتصبُ في وجهي خيالي محذراً إياي: إن فكرتُ أن أنتقد لغة الكاتب، إملاءه النحو، أو حتى إخراج الكتاب!
وفي القصائد كما لم أحب اللهجة العامية – على أنها جميلة جداً وقريبة وشارحة ودقيقة جداً بل ربما أدق من الفصحى – لم أحب أيضاً وكما دوماً؛ لم أستشعر القصيدة النثرية ولا أدري كيف نطقت الكلمة، كيف قلت: القصيدة النثرية وها إنني أكررها! وربما لأنني أعشق الإيقاع، الدوزنة، الأوتار، الغناء، الرقص على أزرار الآلات الموسيقية، والتحليق الذي يبدو دوماً موزوناً وقد شدني - حد الصدمة - تحليق الكاتب أحيانا/ بل كثيراً بدون أوزان الخليل!
نقطة ونص جديد: فأنا الآنَ وصلتُ إلى بلاط النص الفخم، الزاخر، المفحِم، الفاخر جداً...
حين قرأت النص العبقري: المسحوق والأرض الصلبة (1) فكرتُ أن أراسل الكاتب، لسبب لن أخبركم إياه ، ولكنني حين وصلتُ إلى نص المسحوق والأرض الصلبة (2) قررتُ أن أتريث، وأيضاً لن أخبركم عن السبب فتلك أسراري التي أخاف أن تصدأ إن بحتُ بها، ثم بعد بضع نصوص أخرى وصلتُ إلى: المسحوق والأرض الصلبة (3) وأدركتُ سبب عنونة الكاتب للكتاب بهذا العنوان، ثم بدأت ألهث عبر الصفحات العشر المتبقية من الكتاب، أبحث عن بقية لهذا النص الطويل الذي لم أشبع منه بعد! أوووه ليس إلا ثمة سطور عن "البني آدم اللي كتب الكلام ده، على قولة الكاتب" ثمة مساحة للفوضى وأخرى أرحب للعبث.. ونقاط نقاط، نقاط نقاط..... ولا جزء رابع لقنبلة الكتاب: المسحوق والأرض الصلبة!
قلت: بيني وبين نفسي ربما يكون للحديث بقية، بالأصح ربما يكون للبقية كتاب جديد على قائمة مشاريع الكاتب، ولو أنني أثق أن ما أكتبه عن كتابٍ ما؛ يقرأه الكاتب بالفعل لما ترددتُ لحظة في سرد كل ما أشعر عن الكتاب، كل ما أفكر به بينما أقرأ. فكمُّ الحقائق التي أكتشفها وأكتشف لاحقاً أنني أعرفها وهي الآن فقط منمّقة، مكتوبة بصيغة مختلفة عن يوميات الحقائق لديّ، أشعر أننا التقينا – أنا والكاتب – ذات يومٍ وتلقينا ذات الدرس معاً/ كلانا كاتبان، كلانا مسحوقان، كلانا نجيدُ الغناء، وكلانا داهية، أعتقدُ أن البعض الآن عرف لمَ ادّعيتُ أنني أعرف الكاتب! أسأل نفسي أخيراً: سماح؛ أنتِ تقرئين الكُتب، أم الكُتّاب.. وأترك لذكاء خيالي الدفة بعد أن أطلق له رحابة فضاء العنان.
حين انتهى الكتابُ حزنت قليلاً ولستُ أدري هل كان سبب الحزن أن الكتاب انتهى، أم أنني لم أجد جزءاً رابعاً للنص الذي آمنتُ به وأحببته جداً واتخذتُ بشأنه وفي حضرته أكثر من قررا! لكنني تداركتُ حزني فهربت إلى الكتابة، إلى أن خرجتُ بتلك المقالة السريعة عن رحلة لا تتعدى الساعتين مع هذا الكتاب الجميل والخفيف جداً، للكاتب العبقري، القريب، الملهم، الذي عرفته – ليس معرفة شخصية - قبل أيام قليلة: إبراهيم عادل. اسمٌ مصريٌّ جديد ينضاف إلى قائمة الأسماء المصرية المحببة إلى قلبي، وتنسدلُ عليه زهرة أقحوان.
أهلاً بك وبكتبك ونصوصك وإنتاجك الجميل بين دفتي مكتبتي وقلبي الوارفين!
سماح ضيف الله المزين
فلسطين – غزة
في 14 إبريل 2013م